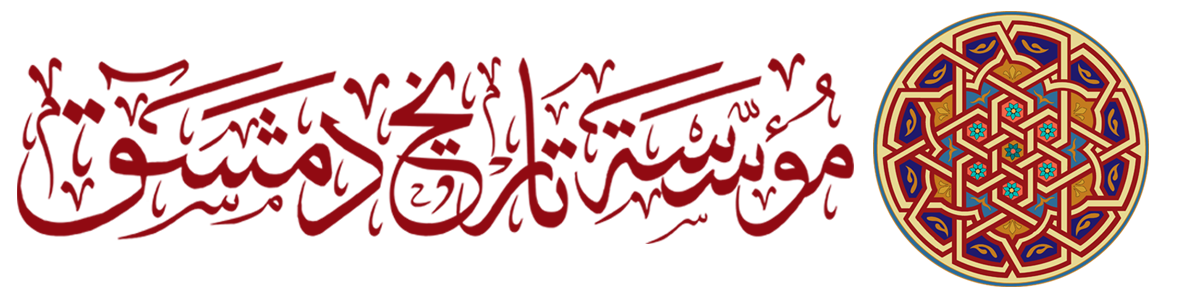تجربة دمشق الوبائية في القرن التاسع عشر: كوفيد ١٩ ليس التجربة الأولى
بقلم: بنان الغفري*
يشارك سكان مدينة دمشق العالم فزعه وخوفه وطُرق احترازه من مرض كوفيد ١٩ الذي يسببه فيروس الكورونا والذي بدأ يغزو جميع مجتمعات وسكان الأرض على حد سواء. إن الذي يميّز تجربة فيروس الكورونا عن غيره من الفيروسات المنتشرة في منطقة واحدة، كونُه وباء عالمياً يغزو أماكن متعددة بعيدة عن بعضها في آن واحد أو في أوقات متقاربة. فلقد شاهدنا كيف هاجم الفيروس مدينة وهان في الصين ومنها انتشر خلال أشهر قليلة إلى إيران وأوروبا، ثم إلى القارات الأمريكية والأسترالية خلال بضعة أشهر.
وأما منطقة الشرق الأوسط فهي الآن تعيش نصيبها من هذا الوباء الذي يبدو وكأنه ظاهرة جديدة لم تعهدها المنطقة من قبل. إلا أن هذا ليس صحيحاً، فمنطقة الشرق الأوسط منذ عصور قديمة كانت تخسر جزءاً كبيراً من سُكانها بسبب الأوبئة التي كانت تصيب المنطقة بشكل متكرر، مثل الطاعون والجدري والكوليرا وداء السل والإنفلونزا.
حتى عام ١٨٤١ كان الطاعون هو القاتل الأساسي والأكبر لأهالي منطقة بلاد الشام، وآثاره الكارثية على أهالي المنطقة جعلته يستحق لقب الوباء إلى حد أنه عندما كان يهاجم مدينة أو منطقة معينة كان الناس يشيرون إليه ويكتفون بكلمة وباء فيعلم الجميع أن المعني هو مرض الطاعون. في مدينة دمشق كان الطاعون يهاجم الأهالي كل عشر سنوات تقريباً وفي كل مرة كان يحصد المئات من الأرواح قبل أن تخف حدّته ويختفي مؤقتاً. وتتعدد الأبحاث التي تتناول مرض الطاعون، وأسباب انتشاره المنتظمة وطُرق توسعه. وقد أصبح الآن من المؤكد أنه كان ينتقل مع انتقال الأشخاص والبضائع في المنطقة. ويجب التذكر أن الطاعون ليس مرض العصور القديمة، فهو ما زال موجوداً إلى يومنا هذا في سوريا كما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مدغشقر. إلا أن اكتشاف البكتيريا التي تسبب المرض واسمها يرسنيا بيستس Yersinia Pestis وطرق انتشارها ساعد العلماء على تطوير مضاد حيوي ضد هذه البكتيريا وساعد المسؤولين على القيام بالإجراءات التي تمنع انتشارها أو على الأقل تحُد من آثارها القاتلة.
أما مرض القرن التاسع عشر الذي أخاف أهالي مدينة دمشق مثل الطاعون أو ربما أكثر هو مرض الكوليرا أو ما كان يعرف بالهواء الأصفر. إن أول تجربة لمدينة دمشق مع مرض الكوليرا كانت عام ١٨٤٨. قبل ذلك العام كان الدمشقيون يسمعون بمرض الهواء الأصفر عندما يعلمون بموت أحد أعيان المدينة القادمين من الحج أو الذاهبين إلى مدينة بيروت، إلا أن تجربتهم الأولى وجهاً لوجه مع المرض كانت في شهر آب من عام ١٨٤٨ عندما قامت الكوليرا بحصد أكثر من ٣٠٠ شخصاً يومياً، وقد استمر المرض حتى شهر تشرين الأول من نفس السنة ويقال إن عدد الموتى وصل إلى ١٠٠٠٠ شخص.
والأمر الذي جعل الكوليرا مرضاً مرعباً ليس فقط نسبة الوفاة التي كان المرض يتسبب بها ولكن طريقة القتل البشعة والمخزية. فالشخص الذي يُصاب بالكوليرا يبدأ بالإسهال والتقيؤ الشديدين في نفس الوقت وبدون إنذار. فقد يكون الشخص في طريقه إلى العمل أو في مكان العمل عندما تبدأ البكتريا بأخذ مفعولها، فلا يكون أمامه وقت للتواري في أماكن خاصة، كما أن الشخص المصاب قد لا يستمر أكثر من ثلاثة أيام فيموت من الجفاف الذي يصيب جسده والذي يسبب مشاكل صحية قاضية.
بعد الإصابة الأولى في عام ١٨٤٨ عادت الكوليرا إلى دمشق مرة أخرى في الأعوام التالية: ١٨٦٥ ثم ١٨٧٤و ١٨٩٢ و١٩٠٢ ولكنها نجت من الهجمة التي أصابت مصر ولم تصل إلى دمشق في عام ١٨٨٣ ثم نجت دمشق مرة أخرى عام ١٨٩١ عندما أصيبت حلب وحماة بالكوليرا، لكنّ الحظ لم يحالفها في عام ١٨٩٢ حيث عادت الكوليرا لتقتل الناس في المدينة وتضر بأعمالهم. وفي كل مرة كانت الكوليرا تظهر في إحدى المدن المتصلة بدمشق إما عن طريق التجارة أو الحج. كان الناس يصابون بالذعر ويرقبون تطورات المرض لكي يتخذوا الإجراءات الاحتياطية. وهنا يأتي السؤال ما هي الإجراءات الاحتياطية التي كان الناس في دمشق يقومون بها أثناء هجمات وباء الكوليرا المتعددة.
تعلم الدمشقيون التعامل مع مرض الكوليرا بعد تجربتهم الأولى معه في عام ١٨٤٨. فهم كبقية المجتمعات حول العالم لم يعلموا سبب انتشار المرض ولا كيفية معالجته أو اتقائه. فلذلك عندما أصابهم الوباء الأول أصيبوا بدهشة ولجأوا إلى رجال الدين الذين كانوا يعارضون الهرب من الوباء مستشهدين بالحديث النبوي عن حكم الخروج من الطاعون: “إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه”. فقد كان من المتعارف عليه بين علماء المسلمين أن الأوبئة هي مصيبة من الله ورحمة في نفس الوقت، فهو اختبار لصبر المسلمين وعقاب لغير المؤمنين، إذاً هو قضاء الله وقدره ولذلك من المحرم الهروب منه. ولأنه كان لرجال الدين السلطة العليا في المجتمع، ولم يكن في دمشق أطباء محترفون غير القليل من الأطباء الأوربيين بالإضافة إلى الحلاقين والدجالين، كانت لهم الكلمة النافذة في الرد على الأوبئة التي تصيب المدينة. أما في مدينة بيروت فكانت ردة فعل الأهالي فيها مختلفة قليلاً عن دمشق، إذ عمد الكثيرون من غير المسلمين للهروب إلى جبل لبنان ظناً منهم أن الكوليرا لا تأتي إلى الأماكن المرتفعة حيث الهواء العليل. وقد نجا عدد غير قليل ممن هرب إلى الأماكن المرتفعة ولكن ليس للسبب الذي كانوا يعتقدون.
عندما عاد الوباء مرة أخرى إلى دمشق عام ١٨٦٥ عمد الكثير من المسلمين وخاصة الأثرياء والأعيان منهم بالإضافة إلى فئة كبيرة من غير المسلمين إلى المناطق المرتفعة وهي منطقة بلودان. ومنذ ذلك الوقت أصبحت بلودان والقرى المجاورة لها مفر المسلمين وغير المسلمين من أهالي دمشق في الأوقات العصيبة. حيث كانوا يأخذون أشياءهم ومؤنهم وأطعمتهم عارفين أنهم سيبقون هناك مدة شهر على الأقل، ولعل شغف الدمشقيين ببلودان والزبداني قد يعود إلى تلك الأيام.
أما رجال الدين فقد أصدروا فتاوى تجيز الهرب من وجه وباء الكوليرا بحجة أن الرسول محمد (ص) لم يقصد الكوليرا بتحريمه الهروب بل فقط الطاعون وبما أن الكوليرا لم تكن موجودة في عهد النبي فليس على المسلمين حرج في الهروب من المناطق التي تجتاحها الكوليرا، وبذلك أجيز للمسلمين النجاة بأنفسهم.
كانت كوليرا سنة ١٨٦٥ فتاكة واستمرت من شهر آب حتى منتصف شهر تشرين الأول، وقد تسببت بموت ونزوح وتشرد العديد من الناس. فبينما فر الأثرياء إلى بلودان لم يبق أمام الفقراء من أهل المدينة إلا الفرار إلى القرى القريبة من دمشق. وقد خلت شوارع المدينة من الناس ليس لبقائهم في منازلهم بل لهجرهم المدينة بشكل كامل مما فتح المجال أمام اللصوص والسارقين لاقتحام البيوت الخالية وسرقة محتوياتها، وهذا ما أدّى إلى زيادة شقاء الناس عند عودتهم إلى منازلهم.
والسبب في لجوء الناس إلى الأماكن المرتفعة أثناء الهرب هو الاعتقاد القديم بأن الأمراض الوبائية المعدية تنتقل عن الطريق الهواء المتعفن. ولم يكن هذا الاعتقاد قصراً على أهالي المنطقة بل كان مفهوماً منتشراً بين العلماء في جميع أنحاء العالم حتى البلاد المتقدمة علمياً، في ذلك الوقت لم يعرف العالم بعد عن الجراثيم والفيروسات والبكتيريا كطريقة لنقل الأمراض. فكانوا يظنون أن الروائح الكريهة تؤثر في نقاء الهواء مما يُخل بتوازن جسد الإنسان ويسبب المرض وهو ما يسمى الآن بنظرية الميازما أو نظرية الهواء العفن. وكان الناس يلجؤون إلى التداوي بكاسات الهواء والعلق ظناً بأن خروج الدم الفاسد يعيد التوازن إلى الجسد ويؤدي إلى الشفاء.
أما الحكومة في تلك الفترة فقد لجأت لعدة طرق لمكافحة المرض. وأولها قطع الطرقات بين المدن الكبرى وخاصة بين بيروت ودمشق، وحلب ودمشق. كما كانت تفرض الحجر الصحي على المناطق التي تظهر فيها الكوليرا، وتمنع الأهالي من الخروج والتنقل بين المدن. وكانت الحكومة تفرض الحجر الصحي على موكب الحج الذي كان يدخل إلى دمشق من الحجاز مرتين في السنة الهجرية، مرة في شعبان عندما يدخل المحمل السلطاني من الشمال قادماً من حلب والأناضول ومرة أخرى في شهر صفر عند دخول المحمل الشامي عائداً من الحجاز. والمكان المعهود الذي كان يقامُ الحجر فيه على الحجاج هو بلدة عين الزرقاء التي تبعد ٢٥٠ ميلاً عن دمشق. ولم يكن يسمح للمحمل بالدخول قبل الحصول على وثيقة سلامة تفيد بصحة الحجاج وإمكانية إدخالهم إلى دمشق.
كذلك قام حاكم دمشق رشيد باشا وقبله الحاكم رشدي باشا بتحسين شوارع دمشق وتعريض طرقاتها وخاصة سوق الحميدية والأهم من ذلك هو تنظيف شوارع المدينة وقنواتها. وظلت هذه الإجراءات متخذة حتى تم اكتشاف الطريقة التي تنتقل من خلالها الكوليرا وهي الماء الملوث. ففي عام ١٨٨٤ اكتشف روبرت كوخ بكتيريا “فيبريو كوليراي” وفي نهاية القرن التاسع عشر تم التأكد تدريجياً من أن الماء الملوث هو السبب الأساسي لانتشار الكوليرا السريع. عندئذ قامت الحكومة تحت قيادة الحاكم ناظم باشا وبأمر من السلطان عبد الحميد الثاني بمنع استخدام مياه نهر بردى ونقل مياه عين الفيجة بالأساطيل الحديدية المغطاة أو المدفونة إلى داخل المدينة ونواحيها. كما أنشأ السلطان أيضا أول مستشفى حديث في دمشق وأسماه المستشفى الحميدي أو المعروف باسم الغرباء وهو الآن مقر رئاسة الجامعة. حيث ضم هذا المشفى ثاني مخبر في المنطقة يقوم بإجراء الفحوصات الطبية المخبرية بعد مخبر الكلية السورية البروتستانية المعروفة الآن باسم الجامعة الأمريكية في بيروت.
وقد أظهرت الأبحاث والاكتشافات الحديثة حول الكوليرا بأن السبب الأول لانتشار المرض هو الماء الملوث ببراز الأشخاص المصابين ببكتيريا فيبريو كوليراي، فعندما يموت أحدهم بالكوليرا كثيراً ما تباع حاجياته الملوثة بالبراز أو تغسل في قنوات نهر بردى الذي كان يغذي المدينة ويسقي غوطتها فعندما يستعمل الناس مياه بردى للشرب أو غسيل حاجياتهم أو سقاية زرعهم يؤدي ذلك إلى السرعة الرهيبة لانتشار الكوليرا بين أهالي المدن.
تعتبر الكوليرا مرض مجتمعي أي أنها تصيب فئة معينة من المجتمع، فهي تنتقي الفقراء الذين يعيشون في أماكن غير صحية لا تحتوي على معطيات النظافة الصحية ولا يمتلكون المال للحصول على المياه النقية أو ليس لديهم الوعي الكافي للقيام بغسل أيديهم بشكل منتظم وتعقيم أماكن عيشهم وملابسهم.
في هذه المرحلة المبكرة من معرفتنا بفيروس الكورونا لا يمكن القول إن كوفيد ١٩ مثل الكوليرا هو مرض مجتمعي. فالفيروس حتى الآن أصاب جميع فئات المجتمع وجميع بلدان العالم الغنية قبل الفقيرة وذلك لقدرة مواطني البلدان الغنية على السفر حول العالم ناقلين معهم المرض إلى كل مكان، مثلما انتشر من الصين إلى إيطاليا. إلا أن المرض سيتحول إلى مرض مجتمعي إذا استمر الحجر الصحي كوسيلة وحيدة لمنع انتشاره بين الناس. عندها سينجو الأثرياء الذين لديهم من المال ما يكفي للبقاء في منازلهم أو لكون عملهم ذهنياً أكثر مما هو جسدي فيتمكنون من العمل عن بعد عن طريق الإنترنت، بينما الأشخاص الأقل ثراء أو المضطرون للخروج من منازلهم لكسب قوت عيشهم سيكونون هم من يتعرضون إلى الفيروس وينقلونه إلى منازلهم وإلى بقية المجتمع. لذلك من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى القيام بالتضامن الاجتماعي ومساعدة من هم أقل حظاً للبقاء في منازلهم حتى تخف حدة الفيروس ويزول خطره.
—
*بنان غرامز (بنان الغفري) ، أصلها من دمشق ، طالبة في مرحلة الدكتوراة في قسم التاريخ بجامعة جورجتاون، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتركز أبحاثها حالياً بتاريخ الصحة العامة في مدينة دمشقة ما بين عامي 1834 – 1920.
الأفكار الواردة في هذا النص تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة تاريخ دمشق.